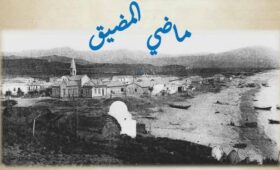تلتصق بالجدار المصبوغ بالجير الأبيض، تمسح بيدها على سطحه البارد وكأنها تستمد منه بعض السكينة والراحة. تشعل الشموع وتضعها حول القبور، وتحرص على إشعال عود الند الذي يعطر المكان برائحة دافئة، تقرأ «الفاتحة» وتبدأ تهمس بأدعية بصوت خافت، وكأنها تهمس بأسرارها للراحلين. تلامس بيدها حائط الضريح وكأنها تطلب عونًا أو حماية، ثم تقبّل الجدار بحب صادق، وترشه بماء الزهر الذي جلبته معها.
كل أسبوع عندما يثقل الضيق على صدرها، تتجه إلى الضريح باحثة عن بركة صاحب المقام. تشعر أن الأجداد والرجال الذين يرقدون هنا هم أهل الأمان، وبركتهم لا تزال حية لكل من يطلبها. ولم يكن ذلك شعورًا فرديًا، بل شاركها فيه أهل القرية ممن اعتادوا زيارة المكان، يتباركون، يدعون، ويتقاسمون السكينة التي تنبع من هذا الضريح القديم.وما إن تنهي طقوسها حتى تبدأ في التحرك، تغادر بهدوء وعلى وجهها طيف ابتسامة وملامح يكسوها شيء من الراحة. وبينما كانت تهم بالخروج من الضريح، كان رشيد يقف عند الباب يتابعها بنظرات فضولية. رشيد، شاب من القرية، معروف بأخلاقه الطيبة، ولا يمسه أحد بسوء. يتمتع بعلاقة طيبة مع جميع أهل القرية الذين ينادونه بـ «الشريف رشيد»، كان قد سمع كثيرًا عن زياراتها، لكنه لم يعرف حقيقة ما الذي يجذبها إلى هذا المكان مرارًا وتكرارًا. تقدم نحوها بخطى هادئة، وعلى وجهه مزيج من الحشمة والفضول، فتح فمه وقال: «عفوًا، …..جدتي ..ا….» لكنه تردد قبل أن يكمل سؤاله.
ابتسمت له بهدوء، قرأت في عينيه ما لم يقله، وأدركت ما يجول في خاطره. ثم قالت بنبرة لطيفة: «لماذا آتي إلى هنا، أليس كذلك يا بني؟» أشار رشيد برأسه، فشدت على عكازها بكل ما بقي لديها من قوة، وضربت به الأرض مرتين في حركة عفوية، وكأنها تخاطب الأرض . قالت بنبرة صادقة تجمع بين الحكمة والحزن: «اسمع يا بني، هذه الأرض التي نقف عليها كانت يومًا لأناس عاشوا هنا مرابطين على ساحل هذه القرية التي تسمى «الرنكون» أو «المضيق»، أبطال أخذوا على عاتقهم حماية هذه الأرض من الغرباء، وقفوا حراسًا بقلوبهم وسيوفهم حتى استشهدوا هنا .
ثم أضافت: «واليوم، لم يعد الأمان كما كان من قبل، وقد غلبني الزمان ، ولم يعد في وسعي سوى المجيء إلى هنا، أقرأ الأدعية وألتمس البركة من هؤلاء المرابطون السبعة .» . أمسكت بيده برفق ونظرت إليه نظرة أخيرة وقالت: «حين يحس قلبك بالضيق، أو في نفسك خوف، تعال إلى هنا يابني واعمل النية… واتكل على الله… النية، يا بني… النية هي سر البركة». ثم مضت ببطء، متكئة على عكازها الخشبي ، وهي تتمتم بكلمات خافتة بينما تتجه نحو البحر وتتلاشى في الأفق
وقف رشيد صامتًا، مسحورًا بكلماتها، يرى في عينيها عالماً لم يعرفه من قبل، وقصصًا من ماضٍ بعيد. شعر برهبة المكان ، وأدرك أن المقام الذي يراه كل يوم ليس مجرد ضريح، بل رمز لحكايات نسجها الزمن عن الفداء والشجاعة. ظل مأخوذًا بالسكينة التي تعم المكان وكلامها الذي بقي يتردد في أذنيه عن حراس قرية «الرنكون» وعن النية التي هي سر البركة، فاستعاد المثل الشعبي الذي يقول «مول النية يربح» و»دير النية وبات مع الحي .
أثرت كلماتها في أعماقه، فانطلق رشيد في رحلة بحث طويلة ليكتشف تاريخ هذا الضريح ، فوجئ بأسرار لم يتخيل عمقها، أسرار مرتبطة بتاريخ القرية التي عُرفت قديمًا اسم «المْضِـــــــيــــق» بكسر الضاد، ثم «فم العليق»، إلى أن استقر اسمها أخيرًا على «الرنكون» أو «المَضْيق». ومع مرور الوقت، أدرك رشيد أن الضريح ليس مجرد أسطورة تناقلتها الأجيال،بل سجلٌ واقعيٌّ لحياة رجال عاشوا هنا. مرابطين كحراس للقرية، وكتب لهم أن تبقى ذكراهم خالدة في هذا المكان .
في الركن الجنوبي الشرقي من القرية، حيث يقع حي «الزاوية» اليوم، يتربع الضريح فوق تل صغير يطل على البحر، في مشهد يعكس رمزًا خفيًا لتاريخ طويل وعريق. يتميز بتصميمه البسيط وأساسه المثلث، ما يمنحه طابعًا فريدًا يجعل منه جزءًا لا يتجزأ من ملامح القرية، حيث يبدو متناغمًا مع البحر والأرض، صامتًا لكنه يحمل في طياته قصصًا وحكايات ،وبعد التنقيب في بعض الارشيفات الاسبانية وجد رشيد أن على بعد أمتار قليلة من الضريح، كان «برج المضيق» يقف شمالًا مشرفًا على الشاطئ، على حافة الواجهة البحرية، واليوم لا يوجد له أثر هدم بالكامل . لقد حمل البرج ذكريات لا تُحصى عن أحداث ووقائع ظل شاهدًا عليها حتى رحيله . تشير بعض الصحف الاسبانية إلى أن هذا البرج قد شُيّد في القرن السادس عشر خلال الغزو البرتغاليي للسواحل الشمالية المغربية . غير أن هناك روايات أخرى تفيد بأن البرج بُني في فترة لاحقة، خلال عهد القائد احمد بن علي الريفي في القرن الثامن عشر للحراسة والمراقبة المبكرة ودعم الدفاع عن المنطقة .لكن بعد البحث والتنقيب الدقيق تبين أن» برج المضيق» كان قائما قبل احتلال البرتغال للسواحل الشمالية، كان البرج له حضور بارز على مر العصور، إذ ظهر على عدة خرائط قديمة جدا كشاهد على أهميته الاستراتيجية. كما ورد ذكره في عدة كتب برتغالية توثّق فترة السيطرة على السواحل المغربية. وما يزيد من قيمته التاريخية، أن الفنان الاسباني الشهير ماريانو فورتوني خلال زيارته لتطوان زار المكان وخلد البرج في إحدى لوحاته بعنوان «يـــوم صيــفــي بـالـمـغـرب «** ليصبح بذلك جزءًا من ذاكرة الفن والتاريخ معًا.
(«ولأن البرج الغامض يحمل بين صخوره وأطلاله اسرارا و حكايات تستحق أن تُروى، سنخصص له لاحقًا موضوعًا خاصًا ومفصلًا نستعرض فيه كل تفاصيله.«)
وعودة الى الضريح وجد رشيد في كتاب «عمدة الراوين« للمؤرخ الفقيه أحمد الرهوني : «على أن الأرض التي بني فوقها هذا الضريح كانت مقبرة قديمة بهذه القرية الصغيرة. التي كانت تعرف بإسم قرية الصيادين (ويقصد الرنكون). وكانت تلك المقابر في أغلبها قبور للجنود المغاربة القدامى الذين كانوا مرابطين بالحصون العسكرية الموجودة في كل “من راس الطرف” و»منطقة كابونيكرو» الذين يحرسون سواحل تطوان. كما يجاورهم في تلك المقابر قبور بعض الصيادين من آهالي هذه القرية … وكانت هذه المقبرة تمتد حتى الموضع الذي بنيت به الكنيسة. -يقصد بكلامه كنيسة سان فرانسيسكو » التي بناها الاسبان سنة 1918 وقد تم جرف جزء من هذه المقبرة القديمة الصغيرة بعد دخول الجيوش الإسبانية الى المنطقة. ومضت القرية عبر سنوات الاحتلال والجهاد لتصبح شاهدة على تاريخ من المقاومة والصمود، حيث حوّل الإسبان جزءاً من المقبرة لإقامة الكنيسة، بينما بقي الضريح شامخاً كعلامةً على صمود هؤلاء السبعة،
وفي رحلته بين الكتب ، عثر رشيد على رواية أخرى ذكرها القاضي محمد السراج في كتابه «خلاصة تاريخ سبتة بالأثر والمأثور وما جاورها من المداشر والقرى حتى كدية الطيفور»، تختلف عن ما وجده في «عمدة الراوين». فقد روى السراج عن إسباني من سكان القرية، جاء من إسبانيا في بداية زمن الحماية، وعمل في الجندية هناك. أخبره. “بأن مكان هذه القبة كان خلوة مليئة بالغابة والأشواك يضع فيه البحارة آلات سفنهم الصيدية، وأن جماعة من المجاهدين أيام حرب عبد الكريم الخطابي كانوا يتعرضون للقوافل التي كانت تحمل الزاد من ريستينكا إلى المضيق فيفتكون بجنودها ويستولون على أزوادها، فجعل الجنود كمينا لهم عند وادي اسمير فقتلوا منهم سبعة ونجا الباقون الذين كان عددهم 80، ثم حملوا على البغال، ودفنوا في مكان القبة في قبر واحد، وعلى هذا فتكون القبة المنسوبة لسبعة رجال قد صادفت محلا للتسمية، والمجاهدون هم أولى بالترحم والإحترام”.
لكن رشيد عثر ما يثبت أن الضريح كان موجودا قبل الحماية 1912 وقبل حرب 1859من خلال ما جاء في قصة من كتاب «المسلمون والمسيحيون» للكاتب الاسباني الشهير بيدروا انطونيودي الاركون الذي شارك في الحرب الاسبانية على المغرب سنة 1958كشاهدا وموثقا عاش بتطوان مدة قصيرة وزار جميع الاماكن فيها . نُشر الكتاب لأول مرة في عام 1880.وجاء على أسلوب قصصي وأدبي . تتحدث القصة عن مسلم من تطوان، اسمه» ابن كريم» والملقب «ب مانوس كوردوس» كان قد عاش في الأندلس خلال فترة الحكم الإسلامي. عندما وقعت الأندلس تحت سيطرة المسيحيين خلال فترة الاسترداد اضطر الرجل إلى المغادرة ، مثل الكثير من المسلمين الذين لجأوا إلى شمال إفريقيا، وخاصة إلى مدن مثل تطوان.قبل مغادرته، قام «ابن كريم» بدفن كنزٍ كبير من الذهب في مكان ما في إسبانيا، معتقدًا أنه سيعود يومًا ما لاستعادته . وعنما جاء الى تطوان وعاش قترة طويلة فكر ان يعود الى اسبانيا لاستعادة الكنز فخرج هو وزوجته من تطوان في اتجاه سبتة وعندما و وصلا الى المضيق ……… يقول الكاتب:
(Mucho y muy regaladamente debió de dormir aquella noche el matrimonio agareno entre los matorrales del camino, pues no serían menos de las nueve de la siguiente mañana cuando llegó al pie de Cabo-Negro. Hay allí un aduar de pastores y labriegos árabes, llamado «Medik», compuesto de algunas chozas, de un morabito o ermita mahometana y de un pozo de agua potable, con su brocal de piedra y su acetre de cobre, como los que figuran en algunas escenas bíblicas. El aduar se hallaba completamente solo en aquel momento. Todos sus habitantes habían salido ya con el ganado o con los aperos de labor a los vecinos montes y cañadas.)………………………………………………….
:الترجمة
لابد أن الزوجين المسلمين قد ناما تلك الليلة نوماً عميقاً ومريحاً بين الشجيرات على جانب الطريق، إذ لم يكونا ليصلا إلى سفحا «كابو نيغرو» قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي. هناك يوجد تجمع صغير للرعاة والمزارعين العرب يُدعى «مديك»، يتألف من بعض الأكواخ، ومرابط أو ضريح إسلامي، وبئر بماء صالح للشرب، محاط بحافة حجرية ودلو من النحاس، شبيه بما يظهر في بعض المشاهد التوراتية. كان التجمع خالياً تماماً في تلك اللحظة، فقد خرج جميع سكانه مع ماشيتهم أو أدوات الزراعة إلى الجبال والوديان المجاورة
أن فضاء ضريح «سبعة رجال» يتحول إلى مسرح للاحتفال بموسم «العمارة » أو «العنصرة»، ذلك اليوم السابع من شهر يوليوز الذي يمثل يومًا رمزيًا عميق الارتباط ب«قرية الصيادين » «المضـــــــيق» وتقاليدها العريقة. يتحول الضريح إلى مركز حياة نابضة،يجمع الزوار من القرى والقبائل والمداشر المجاورة، ويأتي الناس أفواجًا، في مجموعات عائلية مترابطة، يجتمعون في أجواء من الفرحة ، التي تُعبّر عن توقعات طيبة للموسم الفلاحي.
يتحول هذا الضريح الذي بُني ليخلد ذكرى سبعة من الرجال الذين عاشوا لأجل حماية القرية، إلى مساحة للتلاقي والتواصل، حيث يغمر المكان شعور بالترابط بين أبناء القبائل ، فيكتسب موسم «العمارة » «العنصرة» معناه العميق كحلقة وصل تربط الحاضر بالماضي، وأهل القرية بأصولهم. وحول الضريح وعلى مقربة من الكنيسة الكاثوليكية «سان فرانسيسكو»، يقول رشيد: تنتصب خيام متخصصة في عرض المنتوجات الصناعة التقليدية المحلية من المناديل المتعددة الأ شكال والألوان والشواشي المصنوعة من نبات الدوم » العزف» والكرزيات والأحزمة وأغطية الشعر النسائية ، واخرى تعرض فيها بعض الحلي الفضية،ثم أدوات الزينة بكل أصنافها وأحجامها وأشكالها. وخيام لنقش الحناء للزائرين عادة ما تكون تلك النقوش أشكال ورسوم مستوحاة من الطبيعة على شكل ورود وأزهار رائعة الجمال والمنظر. ثم خيام لبيع الحلوى الجبلية الشهيرة المصنوعة محلياً، وهي عبارة عن مكسرات متنوعة الألوان مع السكر المذاب وبذور الكتان.
و في الصباح، يتجول بعض شيوخ المداشر قرية «الرنكون» » المضييق «، ترافقهم «الطقطوقة الجبلية»، حاملين الأعلام الملونة، في موكب يتجه نحو الضريح. وعند وصولهم، تُؤتى بالأضحية وتُذبح على يد شيخ القبيلة أو الفقيه، في مراسم تقليدية تعبر عن الامتنان والوفاء. وتُطهى الأضحية وتُعد في المساء وجبة من طبق الكسكس، يُوزع على الجميع، حيث يتناول الضيوف والفقراء هذا الطعام المبارك، في صورة حية للتواصوال والتقارب بين أبناء القرية والوافدين………….يتبع